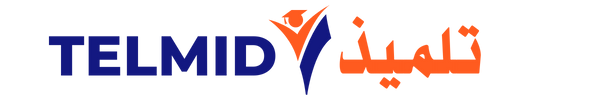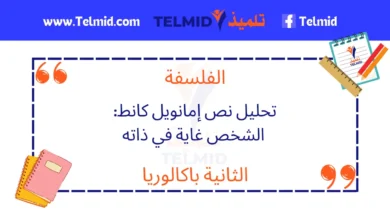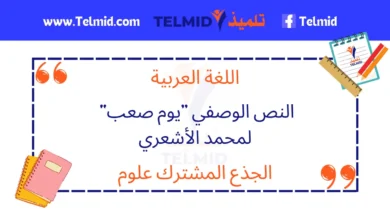المغرب تحت نظام الحماية
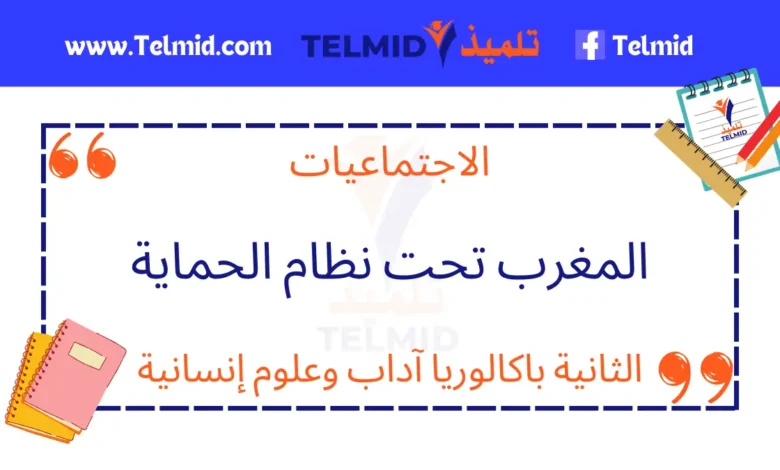
| الثانية باكالوريا آداب وعلوم إنسانية | الاجتماعيات | المغرب تحت نظام الحماية |
المغرب تحت نظام الحماية
المغرب تحت نظام الحماية
تمهيد إشكالي
في العقد الأول من القرن العشرين، شهد المغرب سلسلة من الأزمات الداخلية والخارجية أدت إلى انهيار نظام المخزن، مما جعله عرضة للتدخلات الاستعمارية التي انتهت بفرض الحماية عليه سنة 1912.
- فما هي الظروف التي أحاطت بفرض الحماية على المغرب؟
- وما هو نظام الحماية وأبرز مؤسساته؟
- وكيف تصدى المغاربة لهذا النظام الاستعماري؟
مفهوم نظام الحماية وظروف فرضه على المغرب
مفهوم نظام الحماية
نظام الحماية هو شكل من أشكال الاستعمار فرضته فرنسا وإسبانيا على المغرب ما بين عامي 1912 و1956، إثر توقيع معاهدة فاس في 30 مارس 1912. بموجب هذه المعاهدة، تم تقسيم المغرب إلى ثلاث مناطق نفوذ:
- منطقة النفوذ الفرنسي (الوسط).
- منطقة النفوذ الإسباني (الشمال والجنوب).
- منطقة طنجة الدولية.
الظروف التي أحاطت بفرض الحماية على المغرب
العوامل الخارجية
- التنافس الاستعماري: شهد المغرب تنافسًا بين القوى الاستعمارية الأوروبية، حُسم لصالح فرنسا بعد إبرام سلسلة من الاتفاقيات الثنائية:
- 1902: تنازلت فرنسا لإيطاليا عن ليبيا مقابل المغرب.
- 1904: تنازلت فرنسا لبريطانيا عن مصر.
- 1911: تنازلت لألمانيا عن الكونغو.
- 1912: اتفاق فرنسي-إسباني لتحديد مناطق النفوذ.
- مؤتمر الجزيرة الخضراء 1906: أكد الامتيازات الفرنسية والإسبانية بالمغرب.
العوامل الداخلية
- الأزمة الاقتصادية: ضعف اقتصاد المخزن وفشله في فرض ضريبة الترتيب سنة 1902، مما اضطره للاقتراض المكثف، خاصة من فرنسا.
- الأزمة السياسية:
- تمردات داخلية كتمرد بوحمارة (1902-1909).
- عزل السلطان عبد العزيز وتولية المولى عبد الحفيظ سنة 1909.
- التدخل العسكري الأجنبي:
- 1907: احتلت فرنسا وجدة والدار البيضاء.
- 1911: احتلت إسبانيا العرائش والقصر الكبير.
بنود معاهدة فاس (30 مارس 1912)
تم توقيع المعاهدة بين المولى عبد الحفيظ والمقيم الفرنسي رينو، ونصت على:
- تأسيس نظام جديد تقوم فرنسا بموجبه بإصلاح المغرب.
- إشراف فرنسا على حماية أمن وسلامة السلطان.
- تعيين مقيم عام فرنسي بسلطات واسعة.
- تقسيم مناطق النفوذ بين فرنسا وإسبانيا، مع الإبقاء على طنجة كمنطقة دولية.
التقسيم الترابي للمغرب في عهد الحماية وأجهزتها الإدارية
التقسيم الترابي
- المنطقة الفرنسية: تشمل وسط المغرب وتقسم إلى جهات مدنية وعسكرية.
- المنطقة الإسبانية: تشمل الشمال (جبالة، غمارة، الريف) والجنوب (الساقية الحمراء، ووادي الذهب).
- منطقة طنجة الدولية: منطقة خاضعة لإدارة دولية.
الأجهزة الإدارية لنظام الحماية
الأجهزة الإدارية للحماية الفرنسية
- المستوى المركزي: المقيم العام الفرنسي مسؤول عن إدارة شؤون المغرب (أول مقيم: ليوطي).
- المستوى الإقليمي: تقسيم منطقة النفوذ الفرنسي إلى أقاليم يديرها موظفون سامون فرنسيون.
- المستوى المحلي: إدارة المدن من قبل الباشوات، والبوادي من قبل القواد تحت إشراف الفرنسيين.
الأجهزة الإدارية للحماية الإسبانية
- المستوى المركزي: المندوب السامي الإسباني يتحكم في السلطة الفعلية، تاركًا سلطة شكلية لخليفة السلطان.
- المستوى المحلي: إدارة المدن من قبل الباشوات والقواد بإشراف القناصل الإسبان.
الإدارة المغربية
- المستوى المركزي: خليفة السلطان يختص بالشؤون الدينية والقضائية.
- المستوى المحلي: الباشوات والقواد تحت إشراف الجيش الإسباني.
الأجهزة الإدارية بمنطقة طنجة الدولية
- السلطة التشريعية: مجلس تشريعي يضم مغاربة وأجانب.
- السلطة التنفيذية: حاكم المدينة وممثلون عن المجلس التشريعي.
- السلطة القضائية: تضم قضاة من دول مؤتمر الجزيرة الخضراء.
مظاهر المقاومة المسلحة لنظام الحماية ودورها
مقاومة الاحتلال الفرنسي
- معركة فاس (1912): قادها محمد الحجامي ضد القوات الفرنسية عقب توقيع معاهدة الحماية.
- معركة سيدي بوعثمان (1912): تزعمها أحمد الهيبة، لكنها انتهت بهزيمته شمال مراكش.
- معركة الهري (1914): بقيادة موحا أوحمو الزياني، حققت انتصارًا كبيرًا على الفرنسيين.
- معركة مسكي الرجل (1919): تزعمها الشريف المحمدي العلوي، وانتهت باستشهاد المقاومين.
- معركة بوكافر (1933): بقيادة عسو أو بسلام، واجه فيها مقاومو الأطلس الجيش الفرنسي المدجج بالسلاح.
مقاومة الاحتلال الإسباني
- معركة أنوال (1921): بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي، حقق فيها المغاربة نصرًا كبيرًا على إسبانيا.
- مقاومة جبالة: تزعمها أحمد أخريرو، واستمرت حتى استشهاده سنة 1926.
مظاهر صمود المقاومة
- امتدت المقاومة المسلحة من 1912 إلى 1934، رغم ضعف الأسلحة التقليدية مقارنة بتفوق المستعمر عسكريًا.
- تميزت بارتفاع الروح القتالية والتفاف القبائل حول زعماء المقاومة.
- سعت سلطات الحماية إلى تفكيك وحدة المجتمع المغربي بإصدار الظهير البربري سنة 1930، لكن المغاربة أفشلوه.
خاتمة (المغرب تحت نظام الحماية)
فرضت الحماية على المغرب في ظروف سياسية واقتصادية مضطربة، واستمرت المقاومة المسلحة لسنوات رغم التفوق العسكري الاستعماري. ومع تراجع المقاومة المسلحة، انتقل النضال إلى العمل السياسي، مما ساهم لاحقًا في تحقيق الاستقلال سنة 1956.
تحميل درس المغرب تحت نظام الحماية
لتحميل درس المغرب تحت نظام الحماية للسنة الثانية باكالوريا آداب وعلوم إنسانية اضغط على الرابط في الأسفل: